بين المدينتين .. على جمرِ الوفاء
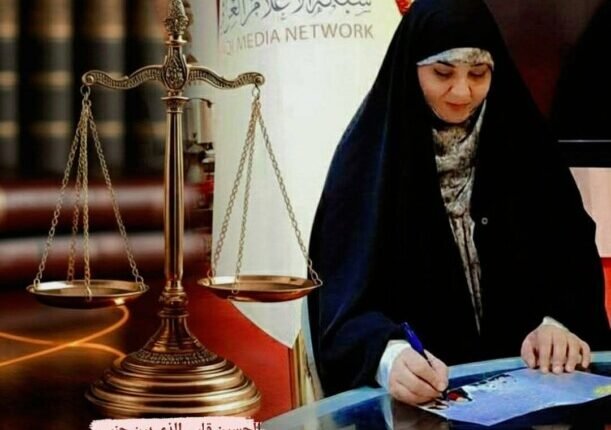
إنتصار الحسين – العراق:
كان الدربُ الممتد بين المدينتين يغصُّ بالحكايا، لكن حكايتي بدأت حين انقطع نَفَسي عند (عامودٍ) تتصاعد منه رائحةُ التمنِ المحروق بحب. هناك، رأيتها.. لم تكن مجرد امرأة، بل كانت (نخلةً جنوبية) متجذرة في الأرض. (عصابتها) السوداء تكلل رأسها بهيبة الملوك، وعلى يديها انطبعت (دكّات) الوشم السومري؛ تلك الرموز الموغلة في القِدَم التي تحكي قصة حضارةٍ نبتت على ضفاف اليقين. كانت تجلسُ بوقار، متحديةً وهج النار، تقلب خبز (السياح) فوق صينيةٍ عملاقة.. وفجأة، اقتربت منها قافلةٌ من الضيوف الأجانب، تحمل ملامحهم دهشة الاكتشاف، وهنا حدثت الالتفاتة التي أوقفت الزمان؛ إذ انبرت من خلف العجوز شابةٌ بملامحَ عراقيةٍ أصيلة ونبرةٍ واثقة، إنها حفيدتها، دكتورة الأدب الإنكليزي، التي بدأت تشرح لهم بطلاقةٍ مذهلة سرّ هذا الخبز وسرّ هذا العشق، وهي تخاطبهم بكلماتٍ تمزج بين الفلسفة والإيمان:
(This is the bread of peace.. prepared by the hands of history, for the sake of the grandson of Ali)
أي هذا هو خبز السلام.. أعدّته يدا التاريخ، لأجل حفيد علي.. كان المشهد صراعاً جميلاً بين صمت الوشم السومري وفصاحة اللسان الأكاديمي، كلاهما ينبعان من منبعٍ واحد.
ولم يكد قلبي يهدأ من سحر هذا اللقاء، حتى استوقفني في خيمة الاستراحة مشهدٌ يخطف العيون ويغسل الأرواح من شوائب التفرقة؛ شابتان في مقتبل العمر، أقامتا الصلاة معاً بانسجامٍ غريب.. كانت إحداهما تمسك بيد الأخرى بحنوّ، تساعدها في فرش سجادة الصلاة وترتيب مكان السجود. وفي منظرٍ مهيب يجسد جوهر الإسلام، وقفتَا جنباً إلى جنب؛ إحداهما تكتفت والأخرى أسبلت، وصعدت التكبيرات من حنجرتين تذوبان في عشق الواحد الأحد، ثم وبقلبٍ واحد، توجهتا سوياً نحو القباب الشامخة للزيارة .. هناك، وفي تلك السجدة المشتركة، أدركتُ أن القلوب حين تتوحد تحت سقف (المحبة)، تسقط كل الفوارق ولا يبقى إلا وجه الله
واصلتُ طريقي ليدخلني الدربُ في هيبةٍ أكبر، حيث انفتح أمام ناظري المضيف الكريم . لم يكن مجرد مكان لإطعام الزوار، بل كان ساحةً لترميم الروح؛ شبابٌ كأنهم من (مواكب النور)، وشيوخٌ وقورون غزا البياض لحاهم حتى صاروا كأنهم (شيوخُ الجنة) الذين نزلوا ليخدموا الضيوف . وفجأة، انشقَّ الهواء بصوتٍ لم يغب يوماً عن الذاكرة؛ إنه صوت الولي الطاهر، ينبعث شجياً عبر الشاشات الكبرى، يشقُّ صمت المسافات وكأنَّ الوليُّ عاد بعباءته وصدره العامر بالإيمان، يشحذُ فينا الهمم بصرخته الخالدة: (هلموا للزيارة).. كان نداءً حياً يبعث القوة في الأجساد المتعبة، ويجعل الأقدام تتسابق نحو المدينة المقدسة.
ومع اقتراب المساء، تداخلت الألوان في لوحةٍ وطنيةٍ باهرة؛ خيمةٌ كردية تلاحم كتفها بخيمةٍ تركمانية، وفي الزاوية، لاحت (أيقونةُ الوفاء)؛ طفلةٌ إيزيدية بملابسها البيضاء الناصعة، تقدم الفاكهة لزوار الجنوب بابتسامةٍ خجولة، وكأنها تقول: (شكراً للجنوب الذي آواني حين ضاقت بي الجبال).. الكلُ انصهر في بوتقة العراق الواحد؛ صورُ المراجع والشهداء تبتسم لبعضها، والبيارغ الخضر ترفرف فوق رؤوس الجميع كأجنحة سلام. في تلك اللحظة، خاطبتُ (زينب) الكبرى في سرّي، والصوت يتهدج في صدري: (أيا أم المصائب، أتسمعين؟ هذا صوت الوليّ يحرث فينا الأمل.. وهذا العراق، بكل أطيافه ومذاهبه، جاء يجدد العهد).
وحين انثنى الطريق لتظهر المدينة ، وقعتُ في شركِ الجمال المطلق. كانت القباب الذهبية قد توشحت بزينة الخامس عشر من شعبان، والأنوار تتقاطع فوقها كأنها عرسٌ سماوي. وفي لحظةٍ بين الحقيقة والوجد، خُيّل إليّ أن ذلك الرجل العظيم يقف هناك، بين المسجدين ، يمسح بيده الشريفة على رؤوس اليتامى والمتعبين، وينثر الضياء في دروب المنتظرين. وصلتُ المدينة المقدسة، وما زالت رائحة (سياح) العجوز في ردائي، وخشوع الشابتين في مخيلتي، وصدى صوت الولي في أذني.. وصلتُ، لأدرك أن هذا المسير ليس نهاية الطريق، بل هو الولادة الحقيقية للإنسان.

